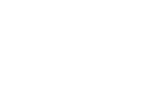قالوا: «إنّ الشیعة یزعمون بوجوب الأصلح، و أنّ الله تعالى لا یفعل بعباده إلّا ما کان بهم حاجة إلیه ما دام الاختیار و التکلیف باقیین، و لا یبیح إلّا ما کان صلاحا، و لا یسوّغ إلّا ما کان صوابا، و یزعمون أنّ المصلحة العامّة للناس کافّة لا تکون إلّا بوجود الإمام و ظهوره و أمره و نهیه و تدبیره، و یستدلّون على ذلک کلّه بحکم العادات فی عموم المصالح بنظر السلطان العادل و تمکّنه من البلاد و العباد، و أنّ المصلحة التامّة و الصلاح الکامل فی مشاهدته و تلقّی معالم الدین و أحکام الشریعة منه بالمشافهة، و مع ذلک یزعمون أنّ الله تعالى قد أباح للإمام الغیبة عن الناس، و أمره بالاختفاء، و سوّغ له الاستتار، و أنّ ذلک هو اللّطف و المصلحة، و هو الصواب بعینه فی التدبیر للعباد و البلاد، و هل هذا إلّا التناقض الواضح الذی لا یقرّه العقل و الدین؟».
و جوابها: إنّ العقلاء کافّة لا یشکّون فی اختلاف المصالح و المفاسد باختلاف الوجوه و الاعتبارات، و أنّ المفاسد تختلف باختلاف أسبابها و أحوالها، و أنّها تتغیّر بتغییر آراء المستصلحین و أغراضهم فی الأفعال، ألا ترى أنّ الحکیم من الناس یدبّر أبناءه و من یلوذ به من أهله و عبیده بما یوجب لهم السعی وراء الأعمال الصالحة لیستحقّوا بذلک الذّکر الجمیل و الأثر الخالد، و ینالوا المدح و الثناء و الإعظام و الإکرام من الناس على الدوام، فیکونوا بذلک موضع ثقتهم و اعتمادهم فی الأمور کافّة من صناعة إلى تجارة إلى وکالة، فیمکّنوهم من الأموال، فیحصل لهم السرور المتواصل، و یتوصّلوا إلى الملذّات بما ینتج لهم من الأرباح؟
و هذا هو الأصلح لهم، و متى و اصلوا الجدّ فی العمل و أخلصوا فیه بأقوالهم، بما یوجب استمرار نشاطهم، سهّلوا
علیهم السّبل الموصلة إلیه، فیکون هذا هو الصلاح العامّ لهم فی عرف العقلاء جمعاء، و إن کانوا على عکس ذلک؛ بأن رکنوا إلى الدّعة، و استسلموا للصدف، و نزلوا فی حمأة السفه، و ارتکبوا الظلم و البغی و سوء الأدب، و عدلوا إلى اللهو و العبث، و صرفوا الأموال فی وجوه الفساد بدل الخیرات، کان الأصلح لهم أن یقطعوا عنهم موارد السعة و الیسار فی الأموال، و کان جزاؤهم- حین ذاک- الاستخفاف بهم و الإهانة لهم و مؤاخذتهم بالعقاب على ما اقترفوا من الفساد، و لیس فی هذا ما یلزم التناقض بین أغراض العقلاء، و لیس فیه تضادّ فی صواب تدبیرهم و طلبهم الصلاح فی الحالتین، بل هو الصلاح عینه و الحکمة نفسها.
و على هذا الوجه الذی حقّقناه دبّر الله تعالى عباده و أراد أن یعمّهم بصلاحه فأوجدهم و أعطاهم عقلا کاملا، و کلّفهم بالأعمال الصالحة بعد أن فرض علیهم الإیمان به لیحلّیهم بالأخلاق الفاضلة و الخصال الجمیلة فی هذه الحیاة العاجلة، و یمدحهم و یثنی علیهم ثناء حسنا و یعطیهم ثوابا عظیما فی الحیاة الآخرة، فإن فعلوا ما أمرهم به و انتهوا عمّا نهاهم عنه کان الواجب فی الحکمة و المصلحة أن یمدّهم بما یزیدهم قرب منه و یسهّل علیهم السبیل و القرآن یقرّر هذا و یؤکّده بقوله تعالى: «وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ» [محمّد: 17]، و قال تعالى: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا» [العنکبوت: 69]، و قال تعالى: «إِنَّ الله مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ» [النّحل: 128]، و قال تعالى: «وَ لَیَنْصُرَنَّ الله مَنْ یَنْصُرُهُ» [الحجّ: 40]، و قال تعالى:
«وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» [الرّوم: 47]، و قال تعالى: «إِنْ تَنْصُرُوا الله یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ» [محمّد: 7]، و إن عدلوا عن ذلک إلى المرود و العصیان، و سلکوا سبیل الغیّ و العدوان، و ترکوا أوامر الله و ارتکبوا نواهیه، و عکفوا على طاعة الأوثان البشریّة و قدّسوا هیاکلها من دون الله و تلقّوا أوامرهم و نواهیهم بکلّ فخر و ترحاب، کان الحال فیما یکون فیه الصلاح
لهم و الصواب فی تدبیرهم أن یقطع عنهم موارد التوفیق و یستبدل ذلک بذمّهم و توبیخهم و ترتّب العقاب علیهم و نسیانهم.و فی القرآن یقول الله تعالى: «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا الله فَنَسِیَهُمْ» [التّوبة: 67]، و قال تعالى: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ» [الأعراف: 96]، و قال أیضا: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً» [الجنّ: 16]، و قال تعالى: «الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما کانُوا یُفْسِدُونَ» [النّحل: 88]، و یکون هذا هو الأصلح لهم و الأصوب فی تدبیرهم ممّا کان یجب لهم فی الحکمة و المصلحة لو أطاعوا و أحسنوا ثمّ اتّقوا و أصلحوا و لزموا طریق السداد و سلکوا سبیل الرشاد. و لیس فی هذا ما یحکم العقل بتناقضه و العقلاء بتضادّه فی قول الشیعة العدلیة، و إنّما هو عین ما یذهبون إلیه من وجوب الأصلح و من جهة اخرى،انه لا یشکّ عاقل فی أنّ الله تعالى دعا النّاس إلى توحیده و أوجب علیهم الإذعان بربوبیّته، و أنّ ذلک هو الأصلح لحالهم و الأصوب فی تدبیرهم، و أنّه لا شیء أصوب منه فی ذلک، و لکن إذا اضطرّوا إلى إظهار کلمة الکفر خوفا على أنفسهم من الهلاک، کان الأصلح لحالهم و الأصوب فی تدبیرهم أن یترکوا الإقرار به و یعدلوا عن إظهار توحیده و یتظاهروا بالکفر.
و کتاب الله یقرّر هذا بقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ» [النّحل: 106]، و قوله: «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» [آل عمران: 28]، و لیس فی هذا شیء من التناقض، و إنّما تبدّلت المصلحة فی الموضعین بتبدّل أحوال المکلّف فیهما، و یکون بتبدّل التدبیر الذی دبّر الله تعالى عباده فی ما أوجدهم لأجله
من توحیده و تصدیق أنبیائه و امتثال أوامره و نواهیه، مصلحة للمؤمنین المتّقین، و إن کان ما یقتضیه فعل الظالمین قبیحا منهم و مفسدة یستحقّون علیه العذاب الشدید.
و نظیر ذلک أنّ الله تعالى قد أوجب الصّلاة و الزّکاة و الحجّ و الجهاد فی سبیله، و أوجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر على المکلّفین أجمعین، و جعل ذلک صلاحا لهم، فإن أستطاعوا علیهما و تمکنوا منها عمّتهم المصلحة، و إن منعهم عنها الظالمون فلم یقدروا علیها کان الأصلح لهم ترکها، و یکونون بذلک معذورین عند الله، و یکون المجرمون المفسدون الذین حالوا بینهم و بین ذلک کلّا أو بعضا هم المعاقبون. فالأمر فی الإمام المنتظر علیه السّلام من هذا القبیل، فإنّه متى أطاعه الناس و أعانوه و نصروه و عملوا على تحقیق ما یرضیه و إزالة ما یکرهه من واقعهم، برجوعهم إلى طاعة الله وحده فی کلّ ما یتعلّق بشئون حیاتهم، کان الأصلح ظهوره لهم و تدبیره إیّاهم، و متى عصوه و خالفوه و طلبوا قتله و سعوا فی سفک دمه و أطاعوا الطغاة و اتّبعوا الظالمین «الذین إِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ – أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ» [البقرة: 11 و 12]، بأنّ ما یزعمونه صلاحا هو الفساد بعینه، تغیّر الحال فی ما یکون فیه تدبیر مصالحهم و تکون المصلحة حینئذ له و لهم فی غیبته علیه السّلام، و لیس على المتّقین الذین یدعون إلى الله تعالى فی السرّحین لا یمکنهم العلانیة من لائمة و لا مؤاخذة، و إنّما اللّوم و العقاب على من سبّب له ذلک بإفساده و سوء اعتقاده و تقاعده عن الدعوة إلیه تعالى، و لا یلزم من أنّ الصلاح فی هذه الحال أن یکون مختفیا غائبا ألّا یجب وجوده؛ لأنّا قد حقّقنا بأنّ ذلک فی هذه الحال هو الأصلح و الأصوب فی التدبیر، کما تقدّم منا .
هذا آخر ما کتبناه باختصار فی هذا الموضوع، راجیا من إخوانی المسلمین أن ینظروا بعین الإنصاف إلى ما أدلیناه
فی هذا المختصر من الأدلّة الشرعیّة و البراهین العقلیّة على ثبوت وجود الإمام المنتظر علیه السّلام، و ظهوره بعد غیبته، ما لا یمکن لمتبحّر فی علم المنقول و المعقول أن یخدش فی شیء منها. و الله أسأل أن یوفّق المسلمین جمیعا إلى التمسّک بحبله، و الاهتداء بهدی نبیّه صلّى الله علیه و آله و سلم، و الطاعة للهداة من آله و التابعین لهم بإحسان من بعده صلّى الله علیه و آله و سلم، إنّه ولیّ التوفیق، و هو حسبنا و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النّصیر.
تمّ استنساخه بقلم مؤلّفه السیّد أمیر محمّد ابن العلّامة الکبیر المجاهد فی سبیل الله السیّد محمّد مهدی الکاظمی القزوینی نوّر الله ضریحه فی الیوم الثالث عشر من جمادى الآخرة، سنة 1374 ه، فی البصرة- العراق.